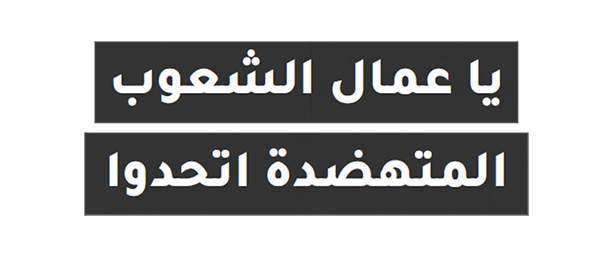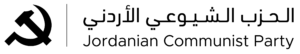ماجد توبة
نحو ثلاثة أسابيع تفصلنا عن موعد الاستحقاق الدستوري بإجراء الانتخابات النيابية للمجلس النيابي التاسع عشر، حيث تدفع كل المؤشرات الرسمية إلى استبعاد اللجوء إلى تأجيل هذا الموعد بغض النظر عن الوضع الوبائي لانتشار الكورونا. ولن يكون من باب التنجيم ولا الضرب في الرمل توقع الخارطة البرلمانية المرتقبة فالمقدمات تقود إلى النتائج، ولا يمكن لأكبر المتفائلين أن يحلم بمجلس مختلف عن المجلس المنحل!
ليس إغراقا في التشاؤم ولا موقفا عدميا مسبقا من مآلات “العرس الديمقراطي” الذي تملأ ألوان يافطاته وصور مرشحيه الشوارع المختلفة وحوائط مواقع التواصل الإجتماعي، بل نزعم أنها قراءة واقعية لمختلف المقدمات القانونية والإجرائية المحيطة بالاستحقاق الانتخابي والتي لا يمكن أن تقود إلا لنتائج مرسومة بدقة، ولا تصب سوى في إعادة إنتاج الإختلالات البنيوية والجوهرية في الحياة البرلمانية التي بدأت مسيرة انحدارها منذ انتخابات 1993 واعتماد الصوت الواحد بصورته المشوهة.
نعم.. تم رسميا تجاوز عقدة الصوت الواحد منذ الانتخابات النيابية الماضية في 2016 وفق قانون الانتخاب، والمطبق أيضا في الانتخابات الحالية بالقفز أماما إلى اعتماد القائمة النسبية المفتوحة على مستوى الدائرة أساسا للترشح والاقتراع، إلا أن الانتخابات الماضية ومخرجاتها كانت تجربة بالذخيرة الحية لعقم هذا القانون ونظامه الانتخابي حيث فشل (وربما كان التوصيف الأصح نجح بتحقيق غايات واضعيه) في إنتاج مجلس نواب قائم على تكتلات وقوائم برامجية حتى بالحدود الدنيا، وبقيت الفردانية هي أساس العمل النيابي مع ما يجره ذلك من تشوهات وقدرة على احتواء السلطة التنفيذية للفعل النيابي!
والمقدمات على الأرض اليوم تتمثل بترشح 294 قائمة انتخابية نهائية بعدد مرشحين يبلغ 1717 مترشحا ومترشحة يتوزعون بدورهم على 23 دائرة انتخابية، مقارنة بـ 1253 مترشحًا مثلوا 226 قائمة انتخابية في الانتخابات الماضية. والثابت أن النظام الانتخابي الحالي يعمل على تشظّي القوة التصويتية للناخبين، وقد عكست النتائج في الانتخابات الماضية مثل هذا التشظي حيث أن معظم القوائم الفائزة بمختلف الدوائر لم تتمكن كل واحدة منها من إنجاح سوى نائب واحد، باستثناءات محدودة ولظروف خاصة تمكنت فيها بعض القوائم من انجاح اكثر من نائب خاصة بالاعتماد على مرشحي الكوتات.
وربما باستثناء قوائم جبهة العمل الاسلامي وتحالف الإصلاح، التي فازت بخمسة عشرة مقعدا في الانتخابات الماضية (انخفضت رسميا تحت القبة إلى 13 مقعدا) لم تتمكن أية قائمة انتخابية من تشكيل كتلة انتخابية تحت القبة، فنظام القائمة النسبية المفتوحة على مستوى الدائرة ودون تحديد عتبة حسم تم هندسته لإعادة إنتاج إفرازات الصوت الواحد.
ما الذي سيختلف في الانتخابات الحالية عما سبق؟ لا شيء؛ فالمتوقع حسب مختلف القراءات أن لا تظفر معظم القوائم الانتخابية بكل المحافظات التي ستتمكن من الفوز سوى بمقعد واحد، فيما سيساعد نظام الكوتات على رفع حصة بعض القوائم القليلة جدا بمقعد أو اثنين آخرين.
هذا الوضع عزز في الانتخابات الحالية من نفوذ مرشحي المال السياسي ومن اؤلئك المستندين الى قاعدة عشائرية كبيرة لبناء كتل هلامية كبيرة نسبيا مليئة بـ”الحشوات” وبما يصب في خدمة المرشح الأساسي صاحب النفوذ والمال، بل ويعزز هذا النظام الانتخابي من التنافس والصراع داخل القائمة الواحدة والانقلاب على التحالفات للظفر بالمقعد الذهبي الوحيد المتاح واقعيا للقائمة!
الأحزاب السياسية وائتلافاتها تبدو بأغلبها “كالأيتام على موائد اللئام” في حمى هذه المعركة غير العادلة ولا المنتجة سياسيا وإصلاحيا، فأغلبها باستثناءات محدودة لا تملك قدرات وامكانات المرشحين من أصحاب النفوذ المالي والسياسي والعشائري، ولا تملك أيضا البيئة السياسية الحاضنة في ظل الاستهداف الرسمي المتواصل والمثابر للحياة الحزبية، ولا يتوقع أن تخرج نتائج الانتخابات المرتقبة بما يتعلق بمرشحي الأحزاب عما تحقق لها في انتخابات 2016.
وحسب دراسات تحليلية للانتخابات الماضية فقد “حصلت القوائم غير الحزبية على أكثر من 70% من مقاعد مجلس النواب، كان غالبية أعضائها يمثِّلون قوى عشائرية ومصالح اقتصادية ومالية”، وحتى الثلاثين بالمائة المحسوبة على القوائم الحزبية فإن الكثير ممن نجحوا منهم، خاصة في الاحزاب الوسطية، اعتمدوا أساسا على قواعدهم العشائرية ونفوذهم السياسي أو المالي.
رغم كل المطالبات الوطنية بضرورة تعديل وتطوير قانون الإنتخاب ونظامه الإنتخابي خاصة بعد تجربة مساوئه وسلبياته عمليا بالانتخابات الماضية فقد اصرت السلطة التنفيذية عليه كما هو، رافضة إدخال أية تعديلات منتجة إصلاحيا ومتوافق عليها وطنيا.
الراهن أن الدولة تبدو، ومع سابق الإصرار، عازمة على تفويت فرصة جديدة لبناء مدماك في عملية الإصلاح السياسي الحقيقي، ولا تخفي حرصها على إعادة إنتاج المجرب الذي يحافظ على تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وبما يساهم أكثر في تآكل منسوب الثقة العامة بالسياسة الرسمية وبالمؤسسات الدستورية رغم كل الخراب القائم والعجز عن التصدي للأزمة العامة المركبة، والتي هي مرشحة للتفاقم والتعمق أكثر!