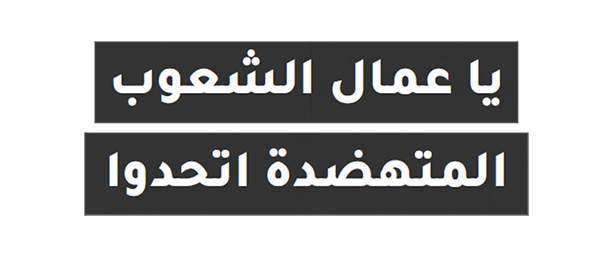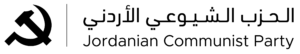مما لا شك فيه أن القطاع الزراعي في الأردن يمثل قيمة إضافية كبيرة للاقتصاد ككل والحياة الاجتماعية، وأن العديد من الحوارات والندوات والمؤتمرات المتخصصة خلال العقود الماضية لتؤكد أن حلول إشكاليات القطاع الزراعي ممكنة لا بل متوفرة.
إلاّ أن هذا القطاع وللأسف لم يأخذ الأهمية التي يستحق وواجه الكثير من التجاهل على مدى العقود الماضية بشكل عام نتيجة للاستقصاء السياسي من جانب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وما اصطلح على تسميته بالانفتاح الاقتصادي.
فمنذ عام 1989 وحتى الآن شهد قطاع الزراعة في الأردن تحولاً من شكل انتاجي يعتمد على تدخل الحكومة في آلية انتاج القطاع الى شكل آخر رفعت فيه يده عنه، الاّ فيما يخص عملية الاشراف والتنظيم “دور رقابي اشرافي” الى حد كبير وهذه التحولات تمثلت في جوانب مؤثرة بشكل مباشر على معيشة وعمل المزارعين وانتاجية القطاع بكل عام. وهذا التحول لم يجر بسبب تغيير أولويات الحكومات بل جاء في سياق برامج التصحيح الاقتصادي والهيكلي التي بُنيت على أساس توجهات صندوق النقد الدولي والتي لم تتوافق مع الواقع في كثير من الأحيان، والتي أدت الى “تأثيرات عكسية” على برامج الاستثمار في القطاع أهمها:
تقليص الدعم، وتحولات العمالة الزراعية
خلال عقدي الستينيات والسبعينيات، تعاملت الحكومة مع القطاع الزراعي بوصفه أحد الموارد الرئيسية للاقتصاد الوطني، وكان هدفها تنمية هذا القطاع وتطويره. حيث أشارت في “خطة السنوات السبع 1964-1971” إلى أن الزراعة كانت تؤمن فرص عمل لحوالي نصف القوى العاملة في الخمسينيات، وحوالي 35% من القوى العاملة في مطلع الستينيات. وحتى مطلع التسعينيات، كانت الحكومة تتكفل بتقديم البذور المدعومة، وتؤمن المياه بتكلفة مناسبة للمزارعين، حيث أن المياه كانت تتلقى الدعم الحكومي. والأهم أن الدولة كانت تحمي المنتج المحلي بفرضها جمارك على المنتجات المستوردة، مما مكّن المزارع من تسويق منتجاته في الأسواق المحلية، وتصديرها بمساعدة الحكومة.
تجلت هذه المساعدة في تأسيس مؤسسة التسويق الزراعي عام 1987، نظرًا لحاجة القطاع لمؤسسة تنظم توزيع وتسويق منتجاته، وأصبحت هذه المؤسسة رسميًا مسؤولة عن “وضع السياسات التسويقية الخاصة بالمنتوجات الزراعية داخل المملكة وخارجها”، وورثت صلاحيات مؤسسات حكومية سابقة اختصت بالتسويق الزراعي. وبحسب قانون مؤسسة التسويق الزراعي لعام 1987، فقد شملت مسؤوليات المؤسسة “وضع الخطط الخاصة بتصدير واستيراد المنتوجات الزراعية ومراقبة تنفيذها”، و”تحديد أصناف وكميات المنتوجات الزراعية المسموح بتصديرها أو استيرادها ومواعيد التصدير والاستيراد”، و”وضع المواصفات الواجب توفرها في المنتوجات الزراعية المصدرة أو المستوردة أو المعروضة للبيع في الأسواق المحلية ومتابعة التقيد بتلك المواصفات”، و”المشاركة في إجراءات تحديد أسعار المنتوجات الزراعية”، و”إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بتسويق المنتوجات الزراعية في داخل المملكة وخارجها بقصد تنظيم العملية التسويقية وتطويرها”.
كانت هذه السياسات متناقضة مع توصيات صندوق النقد الدولي في تقليص الدعم الذي اعتبره تبذيرًا في الإنفاق العام وليس من مهام الحكومة، وطالب الأردن برفع الدعم عن البذور والمبيدات والأسمدة. كما كانت متناقضة مع توصيات البنك الدولي الذي اعتبر وجود مؤسسة التسويق الزراعي “تشوهًا اقتصاديًا”.
ظلت الحكومة حتى منتصف التسعينيات متحفّظة في تعاملها مع صندوق النقد والبنك الدوليين في هذا القطاع. إذ ظلت تقيم الوضع الزراعي تبعًا لمشكلات القطاع محليًا، وأهمها تقلب المواسم المطرية بين القلة والكثرة وتأثر هذا القطاع بهذه التقلبات كون الأردن شحيح بالمصادر المائية، وقلة الأراضي الصالحة للزراعة نتيجة لطبيعة الأرض نفسها، وتأثر الأسواق الخارجية بالتقلبات السياسية، خاصة حرب الخليج الأولى والثانية، الأمر الذي تسبب بإغلاق هذه الأسواق أمام المنتج الزراعي الأردني.
لكن هذا الوضع تغير في النصف الثاني من التسعينيات، حيث بدأ الأردن فعليًا بتطبيق هذه التوجيهات، “وكان أولها قرار حكومي يقضي برفع رسوم المياه وإلغاء دعم أعلاف المواشي والبذور وتخلي الحكومة عن دورها في التسويق بإغلاق مؤسسة التسويق الزراعي، مما أدى لأزمة كبيرة في الريف ككل”
صعّبت هذه القرارات تأمين بعض أهم مدخلات إنتاج القطاع الزراعي، أي الماء والبذور، إضافة إلى الأعلاف، بحيث أصبحت كلفتها مرتفعة على صاحب الأرض. والأمر الأكثر تأثيرًا كان انتقال وظيفة التسويق من الحكومة للفلاح نفسه الذي لا يمتلك مهارات التسويق والدعاية، مما ألجأه لتجار معروفين باسم الوسطاء في القطاع الزراعي، وهم مجموعة من المستثمرين الذين يديرون شركات للمنتجات الزراعية. هذه القرارات أدت لحصول تغير جوهري أحال العمل في الزراعة من عمل ينخرط فيه بشكل رئيسي صاحب الأرض نفسه، من خلال مزارعين أردنيين من أفراد عائلته أو يعملون معه بالأجرة، إلى عمل تنخرط فيه بشكل رئيسي الشركات الخاصة وتتكفل به العمالة الوافدة.
وفضلًا عن تقليص الدعم على المدخلات، وتحويل مسؤولية التسويق للمزارع أو الشركة الزراعية، فقد قلصت الحكومات المتعاقبة الامتيازات التي وفرتها المؤسسات الائتمانيّة المختصة بالزراعة، التي وسبق أنْ أتاحت لصغار المزارعين الوصولَ إلى ائتمان رخيص ومدعوم. كان ذلك بتشجيع من البنك الدوليّ الذي دعا إلى تحرير أسعار المنتجات الزراعيّة والتسويق التجاري، معتبرًا أن هذه السياسات كانت ضرورية “للتغلب على بعض التشوهات التي مثلتها هذه المؤسسات المتخصصة، التي احتكرت أنشطة معيّنة في السوق وتخصصت في بعض أنشطة الاقتراض والإقراض”. بالتالي “حلّ التجار (..) محل مؤسسة التسويق التي جرى إلغاؤها، في توفير البذور والأسمدة ورأس المال لفقراء المزارعين، بتكلفة أعلى بكثير”. كل هذه التحولات ساهمت في التضييق أكثر على المزارعين، الذين أخفَق الكثير منهم في سداد المبالغ المتراكمة عليهم وصولاً للقضاء والمحاكم والسجن، خاصة أثناء فترات الجفاف في التسعينيات، لتصادر محاصيل البعض، وتصادر أراضي قلة منهم.
ومع ارتفاع تكلفة الإنتاج مقابل نسبة الربح، باتت الزراعة غير مجدية ماديًا بالنسبة للكثير من المزارعين، ليعزف أهل الريف تدريجيًا عن الزراعة، وتصبح الشركات التي تمتلك رأس المال اللازم وآليات التوزيع والتسويق هي وحدها القادرة على استدامة عملها في القطاع، خاصة مع دخول العمالة المهاجرة والوافدة وتبين أرقام دائرة الإحصاءات العامة هذا التحول نحو العمالة المهاجرة في القطاع الزراعي.
إلى جانب ذلك، فقد وجهت الدولة جهودها منذ السبعينيات نحو توظيف أبناء الريف في مؤسساتها. بدأ أبناء الريف بهجرة الأرض لصالح الوظيفة الحكومية عن طريق ديوان الخدمة المدنية، وزاد عدد الساعيين لها واتجهوا للدراسة الجامعية بتخصصات تمكنهم من ذلك. وتبعًا لإحصاءات ديوان الخدمة المدنية، فإن نسبة الذين يتم تعيينهم إلى نسبة المتقدمين لطلب الوظيفة قلت بشكل واضح عامًا بعد عام، في مؤشر على تحول شكل الاقتصاد من إنتاجي إلى خدمي، وتزاحم أبناء الريف إما للالتحاق بالجيش أو الوظيفة في القطاعات الحكومية.
هذا التزايد في التوجه نحو الوظيفة عبر التعليم الجامعي، ساهم في ظهور مشكلة جديدة وهي تقسيم ملكية الأرض التي لجأ أصحابها إلى بيعها بغية سداد ديونهم أو إلحاق أبنائهم بالجامعات. فتفتت الملكيات الزراعية حولها إلى وحدات إنتاج صغيرة تصبح الزراعة فيها غير مجدية اقتصاديًا. كما ساهم في ذلك سماح الحكومة بتقسيم الملكيات خارج حدود البلديات إلى مساحات صغيرة. حيث تشير بيانات دائرة الإحصاءات العامة إلى أن عدد الملكيات الزراعية الصغيرة من فئة عشرة دونمات فأقل ازداد بين عامي 1975 و1997 بنحو 182%.
ونتيجة لهذه الآلية فقد تحمل المزارعون في الغالب تكلفة الإنتاج، من تأمين البذور، ومياه الري، والأسمدة، والمبيدات، والنقل. ومن ثم تقوم الشركات بعمليات التسويق، وجلّه قائم على التصدير للأسواق الخارجية. بالتالي، أصبحت الشركات هي المتحكمة إلى حد كبير بأدوات الإنتاج والتسويق في الأسواق المركزية.
ما سبق يفسر ارتفاع نسبة تصدير المنتجات الزراعية، وجلها من محاصيل الخضار والفواكه. هذه النسبة الكبيرة لا تعود على الدولة أو صاحب الأرض بنفع مكافئ لها، فنصيب الدولة من هذه العملية هو فقط قيمة إيجار المساحات التي تتم عليها عمليات البيع والشراء لأصحاب الشركات، ونسبة مقتطعة من المزارعين الأجانب بعد البيع، والضرائب. أما نصيب صاحب الأرض فهو المقابل الذي تدفعه الشركات بهدف ضمان الأرض. وهذا ما يفسر التراجع في نسبة مشاركة قطاع الزراعة في إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الأردني ككل، لتصل 5.4% عام 2018.
ومع مطلع الألفية، استُكمل استدخال القطاع في نظام اقتصادي يعتمد على نظرية السوق الحر، والمنافسة التجارية، بعد توقيع الأردن على اتفاقية “الشراكة التجارية للتجارة الزراعية” أو ما يعرف باتفاقية التجارة الحرة مع مجموعة الاتحاد الأوروبي، تبعًا لتوجيهات الصندوق عام 1997، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ عام 2002. نصت الاتفاقية على تعديل أو إزالة عدد من القيود الجمركية وغير الجمركية، من بينها “إلغاء القيود الكمية على المستوردات والتدابير التي لها أثر مماثل على التجارة بين المجموعة والأردن”، وعدم استحداث قيود جديدة، و”عدم تطبيق المجموعة والأردن بينهما رسومًا جمركية أو رسوم لها أثر مماثل، أو قيود كمية أو تدابير لها أثر مماثل على الصادرات”.
وبرغم استفادة الأردن في هذه الاتفاقية من فرص تصدير أكبر لمنتجات زراعية معفاة من الجمارك، إلا أنها لا تقوم كدولة بهذا التصدير كما كانت سابقًا، بل هو تصدير تحكمه الشركات الخاصة كما أسلفنا. وسمحت الاتفاقية بفتح السوق أمام منتجات الدول الأخرى لدخول الأردن أيضًا بإعفاءات جمركية كبيرة تنافس ما تبقى من المنتجات الزراعية التي تذهب إلى الأسواق العادية، وهي تقريبًا المنفذ الوحيد للمزارع الأردني غير المتمكن من تسويق منتجاته للمحال التجارية أو الأسواق الكبرى بشكل ينافس فيه تسويق الشركات الاستثمارية. وهذا يفسر تفاوت الأسعار بين المنتجات الزراعية في المملكة، وتتجلى فيه أزمة ما يسمى بالوسطاء، فهم يشترون من المزارع الأردني أو المهاجر ثم يبيعون للمحال والأسواق الكبرى مما يزيد من سعر المنتج بفعل حلقة الوصل، ويبخس من نسبة الربح للمزارع الأردني الذي يخسر في هذه العملية أكثر مما يربح.
ويؤكد وزير زراعة سابق من أن تأثير خصخصة القطاع الزراعي كان واضحًا على دور الوزارة في الإنتاج في هذا القطاع. فقد تضاءلت تدريجيًا الخدمات والسلع الكثيرة التي كانت الوزارة تقدمها للمزارعين دون أجر أو بأسعار زهيدة، وتطور بها الأمر إلى أن بدأت الوزارة بالتدريج بالتخلص من هذه المهمة لتوكلها للقطاع الخاص. ومن المفارقة العجيبة هي أنه وبعد عقود على هذا الانسحاب الحكومي من القطاع، عادت وزارة الزراعة لدراسة إعادة إنشاء مؤسسة للتسويق الزراعي، بالتشارك مع القطاع الخاص هذه المرة، «لمواجهة التحديات التي تواجه العملية التسويقية للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
خاتمة
إن برامج صندوق النقد والبنك الدوليين الداعية لتحرير السوق الزراعي ورفع أشكال مختلفة من الدعم الحكومي لهذا القطاع، تكون الحكومات الأردنية قد أضرت بقطاع منتج يؤمن احتياجات الأردنيين من الغذاء، ويؤمن العمل لسكان محافظات كاملة، بمستوى معيشي جيد، وأنتجت نسب بطالة عالية تتنكر لها الآن، بإلقاء اللوم على العاطلين بأنهم غير مؤهلين لدخول سوق العمل، أو بأنهم مستنكفون عنه، وأنتجت مشكلة فقر في محافظات كانت قادرة على تأمين حاجاتها الأساسية.
ما تزال الحكومة تهمش قطاع الزراعة في تعريفها للنمو الاقتصادي، انطلاقًا من تصور مفاده أن القطاع بات محدودًا في تأثيره على الاقتصاد أو قدرته على النهوض به، وتعتمد في تقديراتها للمؤشرات الاقتصادية الأساسية “على الإصدارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وغيرها من الجهات الدولية”، كما تبلغنا دائرة الإحصاءات العامة. بل حتى القرارات المؤثرة بشكل مباشر على القطاع ومزارعيه باتت متعلقة بالصندوق، كما أوضح رئيس وزراء أسبق عندما التقى المزارعين الذين لجأوا للإضراب رفضًا لقرار فرض ضريبة على مدخلات الإنتاج الزراعي، فرد عليهم بأن الحكومة لن تتراجع عن القرار “حتى يتم التشاور مع صندوق النقد الدولي”.